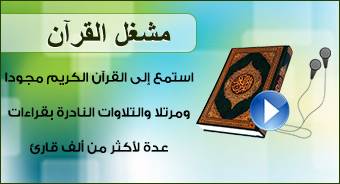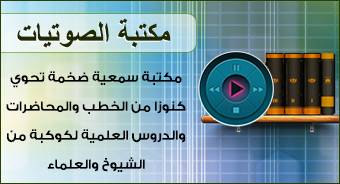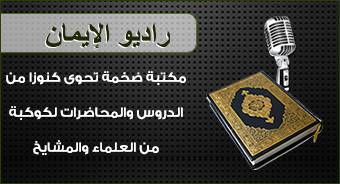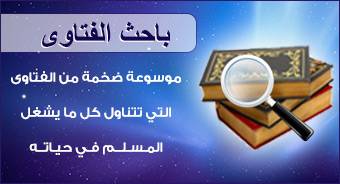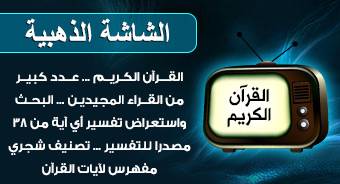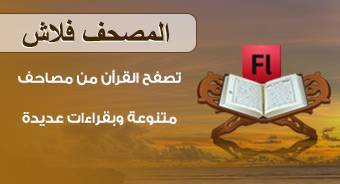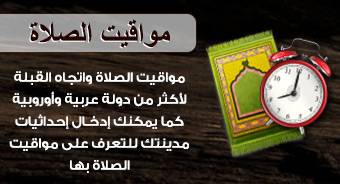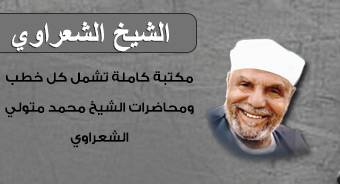|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم
المسألة الثالثة:أنه تعالى وصف الأرض ذلك الوقت بصفات.أحدها: كونها قاعًا وهو المكان المطمئن وقيل مستنقع الماء.وثانيها: الصفصف وهو الذي لا نبات عليه.وقال أبو مسلم: القاع الأرض الملساء المستوية وكذلك الصفصف.وثالثها: قوله: {لاَّ ترى فِيهَا عِوَجًا وَلا أَمْتًا} وقال صاحب الكشاف: قد فرقوا بين العِوج والعَوج فقالوا: العوج بالكسر في المعاني والعوج بالفتح في الأعيان، فإن قيل: الأرض عين فكيف صح فيها المكسور العين؟ قلنا: اختيار هذا اللفظ له موقع بديع في وصف الأرض بالاستواء ونفي الاعوجاج، وذلك لأنك لو عمدت إلى قطعة أرض فسويتها وبالغت في التسوية فإذا قابلتها المقاييس الهندسية وجدت فيها أنواعًا من العوج خارجة عن الحس البصري.قال فذاك القدر في الاعوجاج لما لطف جدًا ألحق بالمعاني فقيل فيه: عوج بالكسر، واعلم أن هذه الآية تدل على أن الأرض تكون ذلك اليوم كرة حقيقية لأن المضلع لابد وأن يتصل بعض سطوحه بالبعض لا على الاستقامة بل على الاعوجاج وذلك يبطله ظاهر الآية.ورابعها: الأمت النتوء اليسير، يقال: مد حبله حتى ما فيه أمت وتحصل من هذه الصفات الأربع أن الأرض تكون ذلك اليوم ملساء خالية عن الارتفاع والانخفاض وأنواع الانحراف والإعوجاج.الصفة الثانية: ليوم القيامة قوله: {يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الداعى لاَ عِوَجَ لَهُ} وفي الداعي قولان: الأول: أن ذلك الداعي هو النفخ في الصور وقوله: {لاَ عِوَجَ لَهُ} أي لا يعدل عن أحد بدعائه بل يحشر الكل.الثاني: أنه ملك قائم على صخرة بيت المقدس ينادي ويقول: أيتها العظام النخرة، والأوصال المتفرقة، واللحوم المتمزقة، قومي إلى ربك للحساب والجزاء.فيسمعون صوت الداعي فيتبعونه، ويقال: إنه إسرافيل عليه السلام يضع قدمه على الصخرة فإن قيل هذا الدعاء يكون قبل الإحياء أو بعده؟ قلنا: إن كان المقصود بالدعاء إعلامهم وجب أن يكون ذلك بعد الإحياء لأن دعاء الميت عبث وإن لم يكن المقصود إعلامهم بل المقصود مقصود آخر مثل أن يكون لطفًا للملائكة ومصلحة لهم فذلك جائز قبل الإحياء.الصفة الثالثة: قوله: {وَخَشَعَتِ الأصوات للرحمن فَلاَ تَسْمَعُ إِلاَّ هَمْسًا} وفيه وجوه: أحدها: خشعت الأصوات من شدة الفزع وخضعت وخفيت فلا تسمع إلا همسًا وهو الذكر الخفي، قال أبو مسلم: وقد علم الإنس والجن بأن لا مالك لهم سواه فلا يسمع لهم صوت يزيد على الهمس وهو أخفى الصوت ويكاد يكون كلامًا يفهم بتحريك الشفتين لضعفه.وحق لمن كان الله محاسبه أن يخشع طرفه ويضعف صوته ويختلط قوله ويطول غمه.وثانيها: قال ابن عباس رضي الله عنهما والحسن وعكرمة وابن زيد: الهمس وطء الأقدام، فالمعنى أنه لا تسمع إلا خفق الأقدام ونقلها إلى المحشر.الصفة الرابعة: قوله: {يَوْمَئِذٍ لاَّ تَنفَعُ الشفاعة إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرحمن وَرَضِىَ لَهُ قَوْلًا} قال صاحب الكشاف: من يصلح أن يكون مرفوعًا ومنصوبًا فالرفع على البدل من الشفاعة بتقدير حذف المضاف إليه أي لا تنفع الشفاعة إلا شفاعة من أذن له الرحمن والنصب على المفعولية، وأقول: الاحتمال الثاني أولى لوجوه: الأول: أن الأول يحتاج فيه إلى الإضمار وتغيير الأعراب والثاني: لا يحتاج فيه إلى ذلك.والثاني: أن قوله تعالى: {لاَّ تَنفَعُ الشفاعة} يراد به من يشفع بها والاستثناء يرجع إليهم فكأنه قال: لا تنفع الشفاعة أحدًا من الخلق إلا شخصًا مرضيًا.والثالث: وهو أن من المعلوم بالضرورة أن درجة الشافع درجة عظيمة فهي لا تحصل إلا لمن أذن الله له فيها وكان عند الله مرضيًا، فلو حملنا الآية على ذلك صارت جارية مجرى إيضاح الواضحات، أما لو حملنا الآية على المشفوع له لم يكن ذلك إيضاح الواضحات فكان ذلك أولى، إذا ثبت هذا فنقول: المعتزلة قالوا: الفاسق غير مرضي عند الله تعالى فوجب أن لا يشفع الرسول في حقه لأن هذه الآية دلت على أن المشفوع له لابد وأن يكون مرضيًا عند الله.واعلم أن هذه الآية من أقوى الدلائل على ثبوت الشفاعة في حق الفساق لأن قوله ورضي له قولًا يكفي في صدقه أن يكون الله تعالى قد رضي له قولًا واحدًا من أقواله، والفاسق قد ارتضى الله تعالى قولًا واحدًا من أقواله وهو: شهادة أن لا إله إلا الله.فوجب أن تكون الشفاعة نافعة له لأن الاستثناء من النفي إثبات فإن قيل إنه تعالى استثنى عن ذلك النفي بشرطين: أحدهما: حصول الإذن.والثاني: أن يكون قد رضي له قولًا، فهب أن الفاسق قد حصل فيه أحد الشرطين وهو أنه تعالى قد رضي له قولًا، لكن لم قلتم إنه أذن فيه، وهذا أول المسألة قلنا: هذا القيد وهو أنه رضي له قولًا كافٍ في حصول الاستثناء بدليل قوله تعالى: {وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارتضى} [الأنبياء: 28] فاكتفى هناك بهذا القيد ودلت هذه الآية على أنه لابد من الإذن فظهر من مجموعهما أنه إذا رضي له قولًا يحصل الإذن في الشفاعة، وإذا حصل القيدان حصل الاستثناء وتم المقصود.الصفة الخامسة: قوله: {يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا} وفيه مسائل:المسألة الأولى:الضمير في قوله: {بَيْنِ أَيْدِيهِمْ} عائد إلى الذين يتبعون الداعي ومن قال إن قوله: {مَنْ أَذِنَ لَهُ الرحمن} المراد به الشافع.قال ذلك الضمير عائد إليه والمعنى لا تنفع شفاعة الملائكة والأنبياء إلا لمن أذن له الرحمن في أن تشفع له الملائكة والأنبياء، ثم قال: {يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ} يعني ما بين أيدي الملائكة كما قال في آية الكرسي، وهذا قول الكلبي ومقاتل وفيه تقريع لمن يعبد الملائكة ليشفعوا له.قال مقاتل: يعلم ما كان قبل أن يخلق الملائكة وما كان منهم بعد خلقهم.المسألة الثانية:ذكروا في قوله تعالى: {يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ} وجوهًا: أحدها: قال الكلبي: {مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ} من أمر الآخرة {وَمَا خَلْفَهُمْ} من أمر الدنيا.وثانيها: قال مجاهد: {مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ} من أمر الدنيا والأعمال {وَمَا خَلْفَهُمْ} من أمر الآخرة والثواب والعقاب.وثالثها: قال الضحاك يعلم ما مضى وما بقي ومتى تكون القيامة.المسألة الثالثة:ذكروا في قوله: {وَلاَ يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا} وجهين: الأول: أنه تعالى بين أنه يعلم ما بين أيدي العباد وما خلفهم.ثم قال: {وَلاَ يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا} أي العباد لا يحيطون بما بين أيديهم وما خلفهم علمًا.الثاني: المراد لا يحيطون بالله علمًا والأول أولى لوجهين: أحدهما: أن الضمير يجب عوده إلى أقرب المذكورات والأقرب هاهنا قوله: {مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ}.وثانيهما: أنه تعالى أورد ذلك مورد الزجر ليعلم أن سائر ما يقدمون عليه وما يستحقون به المجازاة معلوم لله تعالى. اهـ.
قاله قتادة.الخامس: الأمت أن يغلظ مكان في الفضاء أو الجبل، ويدق في مكان، حكاه الصولي، فيكون الأمت من الصعود والارتفاع.قوله تعالى: {وَخَشَعَتِ الأَصْوَاتُ لِلرَّحْمنِ} قال ابن عباس: أي خضعت بالسكون، قال الشاعر: {إلاَّ هَمْسًا} فيه ثلاثة أقاويل:أحدها: أنه الصوت الخفي، قاله مجاهد.الثاني: تحريك الشفة واللسان، وقرأ أُبيّ: فلا ينطقون إلا همسًا.الثالث: نقل الأقدام، قال ابن زيد، قال الراجز: يعني أصوات أخفاف الإِبل في سيرها اهـ.
|